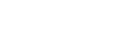كتبت سمية غنوشي أن وجوه الأسرى الفلسطينيين الخارجين من السجون الإسرائيلية تشبه أرواحًا عائدة من الظلال، في مشهدٍ يقابل ابتسامات الأسرى الإسرائيليين الذين أحاطتهم الكاميرات والأضواء. عشرات القنوات عرضت لحظات عناقهم وبثّت أسماءهم، بينما خرج نحو ألفي فلسطيني من زنازين ابتلعت أعوامهم بصمتٍ مطبق، بلا أضواء ولا ترحيب، بوجوهٍ هزيلة وأيدٍ مرتجفة وعيونٍ تحكي لغة الألم.
أشارت ميدل إيست آي إلى المفارقة الفادحة بين الاحتفاء الغربي بالأسرى الإسرائيليين والتجاهل شبه الكامل لقصص الفلسطينيين. كل أسير فلسطيني خرج إلى عالمٍ تغيّر جذريًا؛ بعضهم عاد إلى ركامٍ بدلاً من بيت، وإلى قبور أحبّة بدل أحضانهم. كان الفرح ممتزجًا بالحزن، والانتصار مغموسًا بالمرارة.
تصوّر الكاتبة لحظة عناق المصوّر الصحفي شادي أبو سِيدو لأطفاله بعد عشرين شهرًا من الأسر، وهو يبكي صارخًا: "قالوا لي إنكم متّم وإن غزة اختفت". أمّا الأسير علي السيّس، فاحتضن ابنته التي تركها طفلة فعادت إليه شابة، وهمس لها: "أنتِ وردتي". لكن آخرين، مثل هيثم سالم، خرجوا ليكتشفوا أن عائلاتهم قُتلت جميعًا تحت القصف. انهار وهو يردّد: "أولادي ماتوا".
تصف غنوشي هؤلاء بأنهم عادوا من "المقبرة" لا من المعتقل. بعضهم نُفي قسرًا إلى خارج فلسطين، وآخرون خرجوا بأجسادٍ هزيلة بالكاد تقوى على الوقوف. في الوقت الذي جهّزت فيه إسرائيل فرق دعم نفسي لأسراها العائدين الأصحاء، خرج الفلسطينيون من السجون بعظامٍ ناتئة وجلودٍ مشوّهة من الجوع والضرب. تؤكد الكاتبة أن هذا ليس صدفة، بل سياسة منهجية يشرف عليها الوزير اليميني إيتمار بن غفير، الذي جعل إذلال الأسرى الفلسطينيين جزءًا من مشروعه السياسي.
وثّقت منظمات حقوقية والأمم المتحدة، كما تقول، نمطًا من التعذيب المنظّم داخل السجون الإسرائيلية: ضرب مبرح، صدمات كهربائية، حرمان من النوم، اعتداءات جنسية، وحرق بالسجائر والمواد الكيميائية. الأجساد التي خرجت تحمل هذه القسوة مكتوبة على جلدها. إحدى الأمهات لم تتعرّف إلى ابنها حتى نادوه باسمه، فصرخت باكية: "يا حمزة!" بعدما غيّرت عامان من العذاب ملامحه بالكامل.
تستعرض الكاتبة مأساة الطبيب عدنان البرش، الجرّاح الذي اختُطف من مستشفى العودة ومات تحت التعذيب في سجن "سدي تيمان". وتضيف أن الاحتجاجات في إسرائيل لم تكن ضد الجريمة، بل دفاعًا عن حقّ الجنود في "معاقبة الأسرى"، في مشهد يلخّص انحدارًا أخلاقيًا فادحًا.
تؤكد غنوشي أن إسرائيل ما زالت تحتجز جثامين مئات الفلسطينيين، وتساوم على إعادة جثمان مقابل آخر في "صفقات" تُحوّل الموت نفسه إلى أداة ابتزاز. كل جسد محتجز يعني عائلة محرومة من الحداد، وكل تبادل جثامين يحوّل الإنسان إلى رقم في معادلة سياسية باردة.
تصف السجون الإسرائيلية بأنها "مقابر للأحياء"، حيث لا يُسمح بالدواء ولا بالنور، وحيث تلد النساء مكبّلات، ويُعذَّب الأطباء والصحفيون، ويُحتجز الأطفال بلا تهم. أكثر من 9100 فلسطيني ما زالوا وراء القضبان، بينهم 52 امرأة وقرابة 400 طفل، معظمهم محتجزون بلا محاكمة تحت ما يسمى "الاعتقال الإداري".
وترى الكاتبة أن السجن ليس مكانًا فحسب، بل حالة تلاحق الفلسطيني منذ ولادته. كل بيت فلسطيني يعرف طرقات الجنود في الفجر، والاقتحام، والاختفاء المفاجئ لأحد أفراده. وحتى من يُفرج عنهم يعيشون أسرًا من نوعٍ آخر: حصارٌ دائم، خوفٌ من الاعتقال مجددًا، وحرية مشروطة بثمنٍ لا ينتهي.
تنتقد غنوشي ازدواجية اللغة الغربية: الإسرائيلي "رهينة"، والفلسطيني "سجين". الكلمة الأولى تستدرّ التعاطف، والثانية الإدانة. لكن الحقيقة، كما تقول، أن كل فلسطيني "رهينة" لاحتلالٍ يحاصر الأرض والجسد والوقت.
وترى أن العالم متواطئ في هذا الصمت؛ يبكي على تسعة عشر إسرائيليًا تحت الأنقاض، بينما يغضّ الطرف عن أكثر من عشرة آلاف فلسطيني مدفونين في الركام نفسه. هذا الاختلال العددي، في رأيها، يجسّد قرنًا من نزع الإنسانية عن شعبٍ بأكمله.
تربط الكاتبة بين السجن الفلسطيني وتجارب مقاومة الاستعمار في العالم: مانديلا في جنوب أفريقيا، وبوبي ساندز في إيرلندا، ومناضلو الجزائر وكينيا. السجن في نظرها ليس مجرد عقوبة، بل مختبر للحرية، ومحراب يتكوّن فيه وعي الأمم المقهورة.
تختم غنوشي بأن الأسرى الذين خرجوا هذا الأسبوع ليسوا أفرادًا، بل خيوطًا حيّة في نسيج مقاومةٍ تمتد من التاريخ الفلسطيني إلى حركات التحرر في العالم. إنهم يحملون في أجسادهم الهزيلة نورًا لا يُطفأ — النور نفسه الذي أضاء طريق كل من قاوم الظلم يومًا. لأن قصة الأسير، كما تقول، ليست عن السجن، بل عن الإنسان الذي يرفض أن يُكسر.
https://www.middleeasteye.net/opinion/story-palestinian-prisoners-people-who-refuse-to-submit